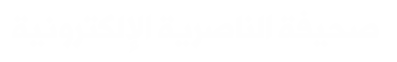كتلة الفضيلة: قانونا الاحوال الشخصية والقضاء الجعفري استجابة واقعية لمتطلبات الدولة المدنية
اكد رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة ان مشروعا قانوني الأحوال الشخصية الجعفري والقضاء الجعفري الذي قدّمه وزير العدل حسن الشمري يمثل استجابة واقعية لدواعي ومنطلقات دستورية وديمقراطية ولسد فراغ قانوني يعالج مسائل ابتلائية للمواطن العراقي”. وقال طعمة في بيان وصل لـــ ( ان المنطلقات الدستورية تتضمن مواد عديدة منها المادة (41) من الدستور التي نصت ] إن العراقيين أحرار بالالتزام في أحوالهم الشخصية وفق ديانتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم .. وينظم ذلك بقانون والمادة (42) من الدستور التي نصّت على ] حرية الفكر والمعتقد والضمير لكل مواطن والمادة 17 من الدستور التي تنص على لكل فرد حق الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والمادة الثانية من الدستور التي نصت على ] لا يجوز سن قانون يخالف ثوابت الشريعة الإسلامي” واضاف طعمة” ان المرجعية الدينية سجلّت اعتراضها الشديد على القانون النافذ الحالي منذ صدوره سنة 1959م لمخالفة مواد فيه لإحكام الشريعة ، واشترط المرجع السيد محسن الحكيم وقتها إلغاء القانون المذكور شرطاً لإستقبال الزعيم عبد الكريم قاسم وعُقدت فعاليات واسعة حينئذٍ للتعبير عن الرفض والاعتراض على القانون (158) لسنة 1959م لتضمنه مواد مخالفة للشريعة الإسلامية وألف فضلاء الحوزة في وقتها كتباً توضح مخالفات القانون للشريعة ونفس هذا المطلب كان حاضراً عند كتابة الدستور وطالبت المرجعيات الدينية بتثبيت المادة (41) في الدستور كأصل وأساس يضمن للإنسان تنظيم أحواله الشخصية وفق ديانته أو مذهبه ومن الدواعي الديمقراطية ولوازمها الأساسية توفير الفرصة والحرية التامة للإنسان بتنظيم سلوكياته الشخصية وفق معتقداته ومتبنياته الفقهية وحفظ وصيانة الخصوصية الشخصية للإنسان ترسخ وتدعم مبدأ المواطنة الصالحة المسؤولة التي تكفل تماسكاً أكبر وتلاحماً أعمق بين مكونات البلد الواحد . على العكس مما لو فُرض على المواطن أحكام غير منسجمة مع معتقده ومتبنياته الفكرية فعندها ينمو الشعور بالغبن والإكراه الذي ينتج غالباً سلوكاً متوتراً وممارساتٍ تمزق المجتمع وتقطع أواصر تماسكه الوطني”. وتابع” ولا يقال كيف يُقنن أكثر من تشريع لموضوع واحد هو الأحوال الشخصية فإنه قد يتعارض مع الدولة المدنية ، فالجواب هو إن الموضوع أولاً: مرتبط بسلوكيات شخصية ذات آثار وابعاد فردية وليست سلوكيات ذات بعد اجتماعي عام حتى يقال بالتعارض والاختلاف. وثانياً: إن طبيعة المجتمع العراقي قائمة على التعدد والتنوع الديني والمذهب ولم تنشأ تلك التعددية من مشروعي القانونين فالشيعي والسني وغير المسلم إختار عقيدته ودينه دون تأثير لهذا القانون وسابقاً عليه والقانونان جاءا لتنظيم السلوكيات بما يحفظ التنوع والتعدد الذي هو حقيقة موضوعية قائمة تقتضي الحكمة ويدعو العقل لإحترامها وعدم إالغائها أو القفز على مستلزماتها بما لا يتعارض مع حقوق الآخرين. وثالثاً: إن مشروعي القانونين لا يؤدي لإلغاء القانون النافذ بل يترك الخيار للمواطن لتنظيم أحواله الشخصية وفقاً لأي منهما” واوضح “أما الداعي أو المنطلق الواقعي الآخر فيتمثل بمعالجة مستجدات المسائل المرتبطة بموضوعات الاحوال الشخصية والتي نتجت جراء تطور العلوم وتطور الحاجات الانسانية وتشعب تفاصيلهما. وتوجد لها أمثلة كثيرة منها التلقيح الاصطناعي وإثبات احكام البنوة والابوة والامومة للمولود وفق معايير الشرع وموازين الفقه وإمكانية إعتماد الوسائل العلمية الحديثة في اثبات موضوع معين كفحوصات الحامض النووي (DNA) فيما يرتبط بموضوعات الاحوال الشخصية وغيرها من الموارد وأمثال هذه القضايا لم يعالجها القانون رقم (188) لسنة 1959 بشكل واضح ومفصل كون تشريعه ذلك الوقت لم يواجه هذه التطورات المنعكسة على موضوعات الاحوال الشخصية وإذا أردنا بيان الحكم القانوني – الشرعي – لها وتضمينه في القانون النافذ فأمامنا ثلاث خيارات لتشريعه أن نعتمد طريقة التصويت بالاغلبية في تبني راي واحد وحكم واحد وهو ما يقود لفرض رأي الاغلبية وإعتقادها على رأي وإعتقاد الاقلية وفي ذلك إكراه وإجبار على تغيير معتقدات الناس فهل ترضى فلسفة الديمقراطية بهذه النتيجة ؟؟!!” وتابع” ان يحصل توافق على الحكم الخاص بالمسألة وهذا ما لا يمكن تصوره وتحقيقه لإن الاحكام الشرعية تمثل إعتقاداً وفيها صبغة تعبدية لا يمكن فرض التنازل عنها للإلتقاء بحكم يمثل حالة وسطية – فرضاً- إذ عندها يخالف الانسان إعتقاده وهذا ما لا يفعله الناس لحرصهم على تدينهم وعقائدهم. بقي الاحتمال الاخير وهو ان تمنح الحرية للفرد أو المواطن بالالتزام بأحواله الشخصية وفقاً لمعتقداته وهو ما يلائم الدستور وينسجم مع حرية الفكر والعقيدة ويحقق الخصوصية الشخصية دونما تعدي على الاخرين,مشيرا الى انه لنا شواهد مماثلة في تشكيلات الدولة العراقية بتعدد الأوقاف الدينية الى وقف شيعي وسني وأوقاف الأقليات الدينية بأعتبار تنوع وأختلاف المعالجات الحكمية لموضوعات ومسائل الوقف وفقاً لديانة إتباعها أو مذاهبهم” . ولفت طعمة” الى انه لم يكن هذا التنوع الإداري الناتج من تنوع الإعتقادات الدينية والمتبنيات الفقهية سبباً لإثارة إجتماعية أو تقاطع مجتمعي بل على العكس من ذلك وفرت حرية لإتباع كل دين ومذهب بتنظيم إلتزاماتهم في تلك المواضيع وفق عقائدهم وجنبتهم الوقوع في مخالفات دينية وهو ما يفترض أن يشكل معلم أساسي في بناء الدولة المدنية.”